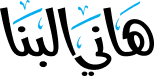الأم والمؤسسات الأربعة البانية للحضارات والنهضات.
دعيت لأتحدث في الإفطار الرمضاني الخيري الذي نظمته مؤسسة ابن رشد الخيرية في مدينة برمنجهام. فسألت القائمين على هذا اللقاء عن موضوع كلمتي، فأرسلوا لي أهدافهم التي يريدون تحقيقها وذكري لها كلمتي والتي منها:
١. أن يصدروا أبحاثا ودراسات إسلامية عالمية.
٢. أن يكن لهم مكانة عالمية بين العلماء والطلاب المسلمين ليجذبوا الباحثين الخبراء ليلعبوا دوراً محورياً في الحوارات العامة التي تخص العالم الإسلامي ومشاكله التي يعاني منها.
٣. أن نهدف إلى إنشاء مكتبة إسلامية على مستوى المملكة المتحدة، لتصبح أكبر مكتبة إسلامية في أوروبا الغربية ليجمعوا فيها العديد من الكتب القيمة والدراسات والمخطوطات والمصادر والإمكانات التي تريدها المجتمعات المسلمة وغيرها. ولا تصبح هذه المكتبة، مكتبة عادية، بل تصبح مكتبة تليق وتتماشى مع حداثة القرن الواحد والعشرين وأصالة الفكر، وتصبح أيضاً داراً للعلو والتعلم لأبناء المجتمع الذي نعيش فيه.
حينما قرأت هذه الرسالة، شعرت بأنها تعتبر عصفا ذهنياً لآمال وطموحات القائمين على بناء صرحاً لتحقيق كل هذه الأهداف والطموحات والإنجازات، وسوف يتعدى هذا المستوى الفكري والثقافي والمعرفي والاجتماعي للحاضرين، خاصة وأن غالبيتهم من أبناء المواطنين من أصول بنجلاديشية وسوف يكون غالبيتهم من النساء والأطفال، وهذا ما نراه في غالبية اللقاءات التي ندعى إليها حديثاً! وتحققت نبوءتي المجتمعية لنجد أن نسبة الحضور من النساء والأطفال قد تعدت ٧٠٪ من نسبة الحضور البالغ عددهم أكثر من ٥٠٠ شخص.
فاتفقنا على أن تكن الكلمة عن قيمة المكتبة في المجتمع، وأن يكن ذلك مدخلاً لمعرفة أبنائنا قيمة القراءة والكتابة والدراسات والبحوث. ففكرت في أن تتكون كلمتي من أربعة عناصر:
١. أهمية وتاريخ إنشاء المكتبات في العالم وما آل إليه مصير هذه المكتبات ومقتنياتها على أيادي أعداء الإنسانية – الخلائقية – في العالم منذ آلاف السنين.
٢. قيمة مؤسسة المكتبة المعرفية في بناء حضارات ونهضات الشعوب.
٣. نبذة عن تاريخ الفقيه الفيلسوف المفكر محمد بن أحمد بن محمد بن رشد العربي الأندلسي (١١٢٦ – ١١٩٨ م) والذي ولد في قرطبة ووافته المنيّة في مراكش.
وبدأت أبحث عن مصادر علميّة للتحدث عن هذه المحاور الثلاث. ولكن هداني ربي سبحانه وتعالى إلى مسار أخر يتحدث عن أهمّ المؤسسات المجتمعيّة التي إن توفّرت وفعّلت ومكنت لاستطاعة بناء مجتمعات قادرة على إحداث التغيير المجتمعي المنشود الباني لنهضات وحضارات الشعوب، وهم:
أولاً: مؤسسة الأسرة التي ركيزتها وراعيتها الأساسية، الأم الحانية العطوفه الدؤوبة.
ثانياً: مؤسسة المسجد – دور العبادة – الذي ركيزته وراعيه الإمام العالم الفقيه الحكيم.
ثالثاً: مؤسسة المدرسة التي ركيزتها الراسخة والأبديّة وراعيها المدرس الأب المعلم صاحب الخبرة والمعرفة.
رابعاً مؤسسة المكتبة التي ركيزتها وراعيها الباحث العالم الملم بأخبار البلاد والعباد والأزمنة والمذاهب والمجتمعات.
ثمّ توكلت فيما بعد على بركة الله تعالى.
١٥ ١٠ من صباح الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤، المنزل، برمنجهام بريطانيا.
أولا: مؤسسة الأسرة:
٠ هي المؤسسة الوحيدة التي لا تستقيم وتستمر وتستديم بدونها الحياة.
٠ هي أول وأقدم مؤسسة خلقها الله في الكون.
٠ هي التي يحتاجها كل كائن حي كوني – وإن كان جمادا – ليقوم بدوره الذي حدده له الخالق.
فمنها الذكر والأنثى، السالب والموجب، الإلكترون والبوزيترون وغير ذلك من مكونات تحتاجها عمليات التناسل والتفاعلات الكيمياوية أو الكهرومغناطيسية للمحافظ على البناء الأسري المجتمعي وديمومة استمرارية المحافظة على إدارة عجلات حركات الحياة المختلفة داخل أتون الكون الفسيح، ووفق قانون أو نظام الناموس الأعظم الذي وضعه الله لبقاء مسيرة كل هذه الحيوات تسير بانسيابية متناغمة مع بعضها البعض وفق عزف ربانيّ وضعه الخالق سبحانه وتعالى لتتنغم وتتناغم وتتهادى وتتمايل على تعبيرات نغم أوتارها، حركة الحياة الكبرى التي تشترك في عزفها كافة الخلائق وفق ” النوت ” المكتوبة لكل منها داخل هذه السيمفونية الجمالية الربانية والت
يشترك في عزف نغمها جوجلبليكس – وهو رقم به ٦٠ صفرا – من الكائنات.
فلنتخيل أيها السادة هذا الأوركسترا المهيب الذي يعزف هذه السيمفونية الربانية والتي يقودها خالق الحياة، دون كلل ولا ملل منذ ملايين السنين.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، في النباتات:
تسمى الأعضاء الأنثوية التي تحتاجها الزهرة للتكاثر بالكربلة وهي الميسم والقلم والمبيض والبويضة، وتسمى الأعضاء الذكرية التي تحتاجها الزهرة للتكاثر بالخيط والمتك المعروفان بالسدادة.
المصدر٤: التكاثر في النباتات الزهرية
OLCreate: TESSA – Westren Sahara -The Open University. open.edu
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=184274…
The Open University TESSA (Teacher Education in Sub-Saharan Africa)
وفي الإنسان والحيوان:
وهي متشابهة لحد كبير – كما كانت من قبل في النباتات – فمنّها ذكري ومنها أنثوي، وقد تعمل أيضاً بطرق متشابهة للحفاظ على أجناسها، ولكنّها – جميعاً – تتفق في ” عنصر الغريزة ” المحافظة على ” الوجود ” وبقاء نوعهم الخلائقي! وهذا وإن دلّ، فإنما يدلّ على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى.
وهذا ما ذكره الله لنوح عليه السلام – منذ آلاف السنين – بعد أن أمره أن يصنع السفينة، فعمم له وحدد كذلك في هذه الآية آمراً إياه قائلا (فإذا فار التنور فاسلك فيها من كلّ زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا منهم، إنهم مغرقون) المؤمنون ٢٧. أمّا التعميم هنا فيأتي في كلّ وأهلك، وأما التحديد هنا فجاء في زوجين اثنين، وإلا من ظلموا منهم، ولا تخاطبني.
فوجه المولى سبحانه وتعالى نبيه نوح عليه السلام إلى أن يحمل معه مجموعة من الكائنات الحية التي سوف تساعده في بناء المجتمعات الحية المحيطة بمجتمعه الصغير – الأسرة – والتي سوف تعينه على ذلك! أمّا باقي الكائنات الحية الأخرى فسوف يجدها منتظرة إياه ومن معه، كي تقيم في ربوع مكوناتها هذه الكائنات الحية – التي جلبها معه – بأمر من الله، والتي منها عائلات النباتات والأشجار، الهضاب والجبال، الأراضي والصحراوات، المعادن والنفائس، الحصى والرمال وغيرها مما يكتمل بوجودها مكونات ديمومة استمرارية حياة الإنسان على الأرض.
أما في حياتنا الاجتماعية اليومية والتي من خلالها نستطيع بناء الشعوب والأوطان والدول، الأخلاق والثقافات والقيم، الأحكام والفرائض والسنن، السلوكيات والمبادئ والذمم، الإيمانيات والعقائد والملل (بكسر الميم وفتح اللام )، المذاهب والطرائق والنحل (بكسر النون وفتح الحاء )، الحب والجود والكرم، الوفاء والإيثار والهمم، العطاء والسخاء والأمل، الأمان والسلام والقمم…… وكل هذا وغيره لا ولن تنبت أشجارها وتثمر أغصانها إلا من داخل أرض ومناخ محضن الأسرة التي ترعاها حق رعايتها ” الأم الحنون الراضية الصابرة، المحبة للخير العابدة المتبتلة، القانعة الشاكرة الذاكره، القائمة الحالمة الراعيه ” والتي يساعدها في مسؤوليتها الأب المسؤول عن أمنها وأمانها فهو كفء لها في الدنيا والآخرة. فلا أسرة بدون أم أمومه، أب ورجوله، عم وفحوله، خال وخؤوله، جار وحبورا ….. فالأسرة ليست زوج ذكر وزوجة أنثى فقط، هي الأسرة هذا المجتمع الذي ذكرته وروحها “الأم ” وقلبها ” الأمومة ” وبصرها ” الحب ” وبصيرتها ” الصبورة ” ورونقها ” الحلم ” وبهاؤها ” السكينة ” والتي من خصائصها:
الأمومة، الحب، الأخلاق، الثقافة، الأجيال، الحياة، الخلائق، الغيب، الفلسفة، اليقين، الإيمان، الجنة.
٣٨ ٠٧ من صباح الإثنين ١ إبريل ٢٠٢٤، المنزل، برمنجهام بريطانيا.
ثانياً: مؤسسة المسجد (دار العبادة والرعاية الاجتماعية):
دعوني أبدأ معكم في شرح خصائص شخصية هذه المؤسسة بهذا البيان أو التصريح أو التصور وهو (لن تفلح أمة أهملت مساجدها – دور عبادتها – وأغلقت أبوابها، أو حددت ساعات اللجوء إلى رحبها، أو أخفنا العامه من ولوج دورها، أو تلصصنا فيها على قول علمائها، أو زرعنا بين صفوف مصليها المنافقين وشياطين الإنس الغادرة ……).
لأنّ ملكية المساجد لله (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) الجن ٢٣، ولأنها (بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب) النور ٣٦ – ٣٨.
وكما كانت الأم هي المحور القائم والمركزي في بناء الأسرة والمجتمع، فإن الإمام العالم الفقيه هو أهم شخصية شعبية جماهيرية، قد تتعدى شعبية جماهيريته الملوك والرؤساء والوزراء والنجوم المجتمعيين الآخرين. فيتمحور حوله كافة الطوائف المجتمعية، حتى وإن كانت غير مسلمة، إن كان حقاً إماماً فقيها عابداً عالماً خادماً زاهداً. لأن قيادة الإمام الفقيه العالم للمجتمعات تعد قيادة روحية وليست قيادة إدارية. فالإمام العالم الفقيه يقود ولا يدير، والمدير العالم يدير بواطن الأمور، ولابد من تكامل أدوارهما. وهذا ما نود أن نلفت به أو إليه أعضاء مجالس الإدارات أو مجالس الأمناء الذين – في غالبية فكرهم أو فهمهم – لا يريدون إماماً له شعبية جماهيرية تتحدى كيانات كينونات مجالس إداراتهم، أو مديراً قائدًا وقادراً على إدراة موظفيه باستقلالية ومهنية معرفية. لذلك نجد أن أسهل شيء يقوم به أعضاء مجالس الإدارات أو أعضاء مجالس الأمناء التي تدير حوكمة مؤسسة المسجد ما يريدون:
إماماً مقيماً للشعائر، ذو علم يستطيع من خلاله معرفة الحلال والحرام، قادراً أن يلقي خطباً أسبوعية في الرقائق وفقه العبادات والمناسبات، مطيعاً ويسمع ما يملى عليه من أوامرهم، يكمل – بسعاده جمه دخله الشهري وبرضا – من الإعانات الاجتماعية التي توفرها الدولة – في الغرب – له. وهذا ما ينطبق أيضاً على المدير الإداري وباقي الموظفين. وقد يعوض مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء هذا النقصان في الجماهيرية الشعبية الفقهية بدعوة ضيوف آخرين من الفقهاء المرموقين – يكلفون المسجد أضعاف ما كان سيتقاضاه الإمام العالم الفقيه – ليشبعوا رغبات المصلين. هذا وللأسف ما يحدث لمؤسسة المسجد مما يجعل المصلين يأتون إلى المسجد اضطراراً لأنهم لا بديل لهم.
وللمسجد في المجتمع المسلم وظائف عدة، كما أنّ للمعابد والكنائس وظائف عدة في مجتمعات أديانها المختلفة. فمن وظائف المسجد:
٠ أنها دور للعبادة ليجد المواطن فيها السكينة والألفة، الود والرحمة، الأمان والنعمه، الفضل والمنه.
٠ إنها دورا يتفقد فيها المواطن أحوال أبناء مجتمعه الذي يتقابل معهم خمس مرات في كل يوم.
٠ إنها دوراً لمعرفة أحوال المسلمين في أرجاء المعمورة.
٠ إنها دوراً للوعظ والإرشاد.
٠ إنها دوراً لممارسة كافة الأنشطة المجتمعية التي يحتاجها المواطنون من الجيران، والتي منها:
أ. تعليم الناشئة وتثقيفهم وتنوير عقولهم وتوعيتهم.
ب. تنظيم الفصول الدراسية لطلبة المدارس.
ت. مناقشة المشاكل الأسرية وإيجاد الحلول لها.
ث. تنظيم الأعمال الترفيهية، الاحتفالات الدينية، الأفراح والأعراس والمآتم، الأنشطة الرياضية، الرحلات الجهوية والمخيمات الخلوية.
ج. مساعدة المعسرين من أبناء المجتمع.
ح. تشجيع ومساعدة الشباب على الزواج.
خ. إيجاد حلول للخلافات التي تنشأ بين المتناحرين من المصلين.
د. بناء القيادات المجتمعية من شباب المستقبل.
٠ أنها بيوت لأموال المسلمين. يعطي فيها أغنيائهم حقوق فقرائهم ليوزعها عليهم علمائهم.
٠ إنها كانت في ظل الدولة الإسلام كانت دورا للحكم، والشورى، والتشريع المجتمعي، والقضاء، والسياسة، والسلطة، وعقد ألوية الجيوش للجهاد في سبيل الله.
وغير ذلك من أنشطة اجتماعية بما فيها بناء العيادات الصحية الملحقة والمستشفيات الملحقة بالمسجد. فأعمار المساجد وآجالها أطول من أعمارنا وأعمار الحكومات المتعاقبة على حكم أوطاننا، وبقاء المساجد أبقى من بقاء دولنا التي صنعت نهضات حضاراتنا! فعلى الدول والأنظمة الحاكمة أن ترعى حرمتها، حريتها واستقلاليتها ولا تتدخل في شئون إدارتها سياسياً، بالمنع أو الحجب أو الإغلاق. فهي ليست ملكاً لحكومات أو دول، ملوك أو رؤساء أو وزراء أو مذاهب أو ذمم، بل لأنها ملكا لخالق الخلق والأمم.
فلذلك علينا أن نعض بنواجذنا على ” فريضة استقلال ” المساجد، ولكن كيف يحدث هذا؟
يحدث باستقلالية الدولة من مؤسستين لا يجوز لهما حكم الوطن. المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، فبالرغم من أن وظيفتهما المجتمعية ” مقدسة ” – لحمايتهما للوطن والمواطن – إلا أنه علينا أن لا نسمح لهما باعتلاء سدة الحكم للتالي:
أ. شخصيتهما المهنية التي جبلوا عليها، شخصية فوقية علويّة آمره، وليست مجتمعية حواريّة متلقية.
ب. مهنيّتهما الوظيفية تتراوح ما بين القتال والقتل – للجيوش – والتشكيك والشك – لقوات الأمن – وهاتين المهنتين لا تستقيمان مع كثرة التغييرات المجتمعية والسياسية والمعيشية والتي هي من خصائص وجود وبقاء المجتمعات.
ت. أن كلتا الشخصيتين تتمتع ” بالسلطوية الاستحواذية التحكمية الشمولية “، فكلتا الشخصيتين لا تثق إلا في أبناء مهنيّتهما، وبالتالي لم ولا ولن تؤمن بمدنية الدولة!
ث. أننا إن تدارسنا تاريخ الشعوب التي حكمتها أنظمة هذه المؤسسات، لوجدنا أن نتيجتها واحدة. ولقد أدت أنظمة حكمهما إلى حدوث العديد من المشاكل الاقتصادية، السياسية، الأدبيّة، الفنيّة، الثقافيّة، التاريخية، الأخلاقية، القيمية، الإيمانيّة، العلميّة، العقائديّة…. وغيرها من المجالات الأخرى، وهذا ما يشهد عليه قراءة تاريخ حكمهم لأوطانهم خلال القرن الماضي. فعلينا جميعا أن ندرس تواريخ حكمهم هذه.
إن القضية لا تكمن فقط في حكم المؤسسات الغير مدنية – العسكرية والأمنية – بل تكمن أيضاً في قضية مدى ” وعي المواطن ” بحقوقه وواجباته وما هي مساحة الحريات العامة المكفولة لكل مواطن. لذلك عليّنا أن نعمل جميعاً مواجهة هذَا التحدي الكبير، رفع وتمكين الوعي المجتمعيّ في توجيه مجالات إدارة شؤون المجتمعات بما فيها الحفاظ على مساحات الحريات الضامنة لاستقلالية إدارة شؤون مؤسساتها، كي تحقق كلّ منها أهداف رسالتها المجتمعية.
ومن العناصر الأساسية لاستقلالية المؤسسات المدنيّة وجود أوقاف مدنيّة لها، مصادر دخل – أخرى – ثابته ومتنوعة، استثمارات ونذور ووصايا، إصدارات وأدبيات وثقافات وخدمات مدرة للدخل ومولدة للاستقرار والاستقلال المؤسسي!
ومنها أيضا ما يكمن مسارات إدارة المؤسسات. وللإدارة هنا مجالات:
أ. الإدارة الجماهيرية الشعبية، والتي يتصدرها الإمام العالم الفقيه.
ب. الإدارة الهيكلية، والتي يتصدرها العاملين من جهة، ومن جهة أخرى مجالس الإدارات أو الأمناء القائمة على الكفاءة والحوكمة.
ت. إدارة المتطوعين من أبناء الأحياء من المواطنين.
ث. إدارة الأوقاف والاستثمار.
ج. إدارة الإعلام والفنون والثقافة والدراما.
ح. إدارة الفقه المجتمعي والفقه الشرعي.
خ. إدارة الرياضة وألعاب القوى.
وغيرها من إدارات ننشئها داخل مؤسسة المسجد لتحافظ على استقلالياتها، ويصبح لزامًا علينا بعد الاتفاق على الهيكل الإداري التنظيمي، نتفق على:
أ. كتابة الوصف الوظيفي لكل وظيفة نحتاجها لإدارة أعمال مؤسسة المسجد.
ب. كتابة صلاحيات وميزانيات كل إدارة وعلاقتها مع الإدارات الأخرى.
ت. اتباع مبدأ الشفافية في كافة أمور الأعمال التي نقوم بها في المسجد ومنها الإعلان عن الوظائف التي يحتاجها المسجد وتكون رواتب الموظفين مناسبة للمعيشة ” بكرامة ” داخل مجتمعاتهم، وألا يعتمدوا على الدعم الحكومي المجتمعي الذي تمنحه الحكومة ” لمحدودي الدخل توفيرا للإنفاق!
ث. الممد الزمنية لعضويات مجالس الإدارات أو الأمناء.
ج. المدد الزمنية لعقود الموظفين ودوريات تجديدها بعد مراقبة ومراجعة أعمال الموظفين.
٣٠ ١١ من صباح الثلاثاء ٢ إبريل ٢٠٢٤، المنزل، برمنجهام بريطانيا.
ثالثاً: مؤسسة المدرسة:
المدرسة هي البناء – الهيكل – المؤسسي والتربوي – الأخلاقي القيمي -الذي يتلقى فيه الطلبة علمهم، ويتم الكشف عن قدراتهم ومهاراتهم التي تتناسب مع ميولهم واحتياجاتهم. إذ تعمل المدرسة فيه جنباً إلى جنب مع الأسرة لتنشئة الأجيال، وزرع القيم والأخلاق، وتنمية إمكانياتك، وصقل شخصياتهم. كما تعمل المدرسة على حث الطلبة وتشجيعهم للحفاظ على قيم مجتمعهم وعاداته.
وهي رحلة عمر، فهي مجموعة مراحل يمرّ فيها جميع الأطفال – إن أمكن – منذ نعومة أظفارهم حتى مراهقتهم وشبابهم. فهي البيت الثاني والمعلم والمربي الذي يصقل الطفل ويقومه ويغني مهاراته ويبرز مواهبه ويوجّهه إلى الطريق الصحيح.
المدرسة والطالب، محمد الحمزة، العربية alarabiya.net
فهي كالمؤمن للمؤمن أو كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، كما قال الإمام ابن تيمية، مجموع الفتاوي، (٢٨/٥٣).
كتاب رسالة عاجلة للدعاة ص ٤٥، خالد بن ثامر السبيعي، المكتبة الشاملة shamela.ws
أو كما ورد – مجازا – في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا) وشبك المصطفى بين أصابعه، حديث صحيح رواه البخاري.
الإمام ابن باز، الحكم على حديث (المؤمن للمؤمن كالبنيان….)، تطبيق مجموعة الفتاوى البازية، نور على الدرب binbaz.org.sa
وهي الأم الحانية – الثانية – والأب الراعي – الثاني – المتكاملة في أدوارها مع المؤسسة المجتمعية المركزية والمحورية في نفس الوقت. فأنا شخصياً أعتبرهما كاليدين أو كالبنيان لأهميتهما القصوى في بناء المجتمعات والدول، صناعة القيادات والأمم، إقامة النهضات وتشييد الحضارات! وإن خيرنا – في أعمالنا الاجتماعية – بين بناء المسجد أو المدرسة لعدم توفر الميزانيات لبناء كلاهما،فسوف أختار بنا المدرسة التي سوف تصنع المواطن المتعلم الواعي الواعد الفاهم الخلوق والذي فيما بعد سوف يكون قادراً على بناء المسجد، لما جاء في ي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ٤٢٧ ٤٣٨ – حدثنا محمد بن سنان: ثنا هشيم: ثنا سيار – وهو : أبو الحكم: ثنا يزيد الفقير: ثنا جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر الحديث وفيه (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل أدركته الصلاة فليصل)، البخاري.
فتح البارى لابن رجب الحنبلي، [ص: ٤٤٤] ٥٦ – باب، المكتبة الإسلامية، إسلام ويب islamweb.net
وببركة فهم معنى هذا الحديث الشريف ظلّ المسلمين – من الأقليات المهاجرة إلى بلدان غير مسلمة – يصلون في الكنائس والمباني العامة الأخرى إلى أن تيسر لهم بناء المساجد. وإن نظرنا إلى حقبة الدعوة المكية – حيث لم يكن الإسلام والمسلمين ممكنين فيها – لوجدنا أن المسلمين كانوا يصلون فيها في بيوتهم أو في شعب من شعاب مكة إلى أن أصبح المسلمين ممكنين في المدينة، حينها أسّسوا مؤسسة المسجد.
هذا بالنسبة للمدرسة كركيزة محورية مؤسسية في بناء الوطن والدولة. ولكن دعونا الآن ننتقل من أهمية المؤسسة التعليمية إلى مركزية ” روحها ” الهائمة والمحلقة داخل أفئدة كل من يعملون بها أو من يتعلمون فيها. فهذه الروح وهذه الروحانية هي القوة الجاذبة المجمعة (للعقول والسرائر، والبعيد والقريب)، الحانية المتراحمة (الرحماء يرحمهم الرحمن)، المعلمة الهادية (إلى سبل الرشاد)، الراضية (بعطاء ربها) المرضية (لمجتمعها في الحق)، الواعية المستوعبة ( لكل ما يحدث من حولها)، الرحيمة الغافرة (لزلات من ظلمها)، اللطيفة المسامرة (للمتعلمين حبا لإعلامهم)، الأليفة الآلفة (لكافة الأفئدة والقلوب)، الفضيلة الفاضلة (في قولها الذي لا يخالف فعلها)، الحبيبة المحببة (لطلب العلم والمعرفة)، المسامحة المتسامحة (مع نفسها)، الحازمة العادلة (مع المحببين والمخالفين)، الزاهية الزاهرة (بأبنائها)، العابدة الخاشعة (لربها)، الصابرة الشاكرة (في السراء والضراء)، الباذلة المضحية (من أجل بناء قيادات المجتمعات)، الناشرة الباسطة (لمتون المعرفة)، البسيطة المبسطة (لعظام الأمور)، العزيزة الغالية (أمام كلّ عزيز)، العالية المستعلية (بالحقّ)، الميسورة الزاهدة (في متاع الغرور)، العصية المستعصية (على الباطل)، القويمة المقومة (للأخطاء)، الشديدة (مع الأقوياء) اللينه (مع الضعفاء)، الحليمة الحالمة (بصناعة مستقبل أفضل للبشرية)، المجتهدة الجاهدة (لصناعة التغيير المجتمعي المنشود)، المبدعة المتجددة (لتجدد ثمار أغصان شجر الحياة)، الممكنة المغيرة (مغيرة لمسيرة المجتمعات بتمكين أبنائها). فما هي روح هذه المؤسسة التي نتكلم عن بعض خصائصها هذه؟ ومن هي/هو صاحب أو صاحبة هذه الروح؟ إنه المعلم والمعلمة ” الممكنين ” من الدولة في القيام بدورهما المجتمعي القيمي التربوي العلمي المهني والذي من خلال القيام به بحرية تنطلق أرواحهما لتتميز هوية شخصيتها بهذه الصفات التي ذكرت من قبل ويشترك فيها معهما ” الإمام العالم الفقيه القائد الجماهيري النبيه “.
أمّا عن قيمة المعلم فقد ذكرها أمير الشعراء في قصيدته الخالدة:
قم للمعلم وفّه التبجيلا …. كاد المعلم أن يكون رسولا.
أعلمت أشرف أو أجل من الذي ……يبني وينشئ أنفسا وعقولا.
أخرجت هذا العقل من ظلماته ….. وهديته النور المبين سبيلا.
وطبعته بيد المعلم تارة ….. وصدى الحديد وتارة مصقولا.
الديوان، مصر، أحمد شوقي، قم للمعلم وفه التبجيلا aldiwan.net
فكيف ” نمكن المعلم وما هو المنهج ” الذي سوف يدرسه للتلاميذ؟
أ. كيف نمكن المعلم:
٠ أن نوجد في المجتمع الذي يعمل فيه مساحة كافية من الحريات التي تجعل روحه قادرة على الانطلاق في أعنان سماوات الحياة.
٠ أن نوفر له في مؤسسة المدرسة كل ما يحتاجه من أدوات وإمكانات تعليمية إيضاحية لتعليم المواد التي يدرسها للطلاب.
٠ أن نوفر الدخل الكافي الذي يجعله يعيش حياة كريمة ومستقلة تمنعه من الخوض في إعطاء الدروس الخصوصيّة للطلبة في منازلهم!
٠ أن نشرك المعلمين في وضع المناهج التي يدرسونها للطلاب.
٠ أن نجعل له خصوصيات مجتمعية أخرى من خلال دعم نقابات العلم والمعلمين، وكذلك بعد سن التقاعد.
٠ أن نجعل له/لها صوراً ذهنية مبجلة أمام المسؤولين والمجتمع الذي يعيشون فيه.
٠ أن ندعم مسيرة العلم والتعليم ولا نتركها فريسة سهلة في أيادي القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
٠ أن لا نكن له – كدولة أو حكومة – قوة طاردة تجعله يطلب الرزق خارج حدود الوطن، بل نصبح لهم قوى جاذبة وقادرة على العطاء.
٠ أن لا نجعل الترقيات بالتقارير السريّة والأمنيّة والاستخباراتية، بل بالجد والكفاءة والعمل والجد والاجتهاد والنتائج المرجوة الحقيقية التي يحققها مع التلاميذ.
٠ ألا نجبر المعلم على تدريس مواد ليست من تخصصه.
٠ أن نوفر لهم الإمكانات لحضور الدورات التدريبية والتأهيلية وورشات العمل والمؤتمرات لاكتساب مهارات جديدة والاطلاع على المستجدات في المنظومة التربوية التعليمية من خلال معرفة تجارب الآخرين.
ب. المنهج الدراسي:
١. أن يشارك في وضع المنهج الدراسي كوكبة من المتخصصين في المجالات التالية:
. الأكاديميين المتخصصين في الأمور التعليمية المهنية المختلفة.
. رجالات الدين لمراجعة بنود القيم والأخلاقيات الثقافية والاجتماعية.
. متخصصين في دراسة تاريخ المجتمعات والدول.
. أطباء نفسيين متخصصين في مدى تقبل التلاميذ حسب فئاتهم العمرية.
. مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال.
. شخصيات مجتمعية مرموقة ومتخصصة فى أبعاد مجالات التعليم.
٢. أن لا يكون غريباً ثقافة وقيم وأخلاقيات المجتمع.
٣. أن يكون متماشياً مع احتياجات المجتمع المهنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
٤. أن لا يكون مسيساً من قبل الدولة أو أنظمة الحكم.
٥. أن لا يوضع ولا يدار من خلال الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
٦. أن يراجع المنهج دوريا وفق احتياجات المجتمعات التي يعيش فيها التلاميذ والطلاب.
٧. أن لا نعتمد سياسة ” الاستيراد المنهجي التقني دون دراسة ومراجعة وتحليل ” لأنها قد تكون مغلفة بأغلفة فكرية، ثقافية، فلسفية، قيمية، أخلاقية وعقائدية – لن نلحظها – ولكنها سوف تؤثر على مجتمعاتنا – فيما بعد – سلباً أكثر منه إيجابا، فليس كل ما ينجح عمله في مكان ما سوف ينجح إن قمنا بعمله في مكان آخر. وكذلك علينا ألا نتبع قاعدة ( مقاس واحد يناسب الجميع One size fits all). فالنجاح قبل أن يكونا تطبيق منهجي لبرنامج معين، فهو يتكون من منظومة مركبة معقدة ومركبة في نفس الوقت، بل يعتمد على عناصر عدة قوية منها: الثقة، الإيمان، اليقين، المحاولة، الإصرار، التشجيع، التمكين، القدوة، الحاجة، القدرة والمهارة والصبر والمثابرة.
٢٢ ٠٩ من صباح الأربعاء ٣ إبريل ٢٠٢٤، المنزل، برمنجهام بريطانيا.
رابعا: مؤسسة المكتبة:
ما هي المكتبة:
هي كيان أو مؤسسة تنشئها الدولة أو مؤسسات أخرى أو أشخاص لتوضع فيها الكتب، المخطوطات، النشرات، المجلات، الجرائد، الإصدارات للمدارسة والبحث والاطلاع. وحديثاً أضيف إليها أقسام: السمعيات (الراديو والتسجيلات)، المرئيات (الأفلام والتسجيلات الوثائقية والإخبارية والتاريخية والعلمية والأدبية والثقافية …)، الفنون ومنها الرسم والنحت والموسيقى، الاطلاع الالكتروني (عبر الإنترنت). وهي في غالب الأحيان ما تكون بالمجان لكي تصبح خدماتها في متناول كافة أبناء المجتمع، وخاصة من أبناء الطبقات الفقيرة والأقليات والمهاجرين.
هي أيضاً دارا للنقاش وعقد الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل.
هي أيضاً محرابا للعلم والفكر والتدبر والإبداع.
هي أيضاً مناخاً يعيش بداخله القارئ، والدارس، والباحث والمحلل ليجد فيه ضالته المنشودة.
هي أيضاً ملتقى لأصحاب الخصائص والاهتمامات المتشابهة والتوجهات المختلفة.
هي أيضاً معبداً للروح والنفس الهائمة في أبعاد ومجالات التاريخ الحضاري النهضوي الذي بناه الأجداد، أضاعه الأبناء وعانى من عدم العيش في مجريات بهائه الأحفاد.
هي أيضاً المؤسسة الوحيدة التي تجمع الماضي بأحداثه، الحاضر بتغيراته والمستقبل بآفاقه.
هي أيضاً المؤسسة الوحيدة التي تجتمع فيها كافة المتناقضات: الحقيقة والخيال، الحلم والواقع، الكذب والصدق، النفاق والأمان، الجهل والعلم، الإلحاد والإيمان، الجمود والتجديد، التخلف والابتكار، الموت والحياة، الشرف والعار، الخيانة والوفاء، البخل والسخاء، المنع والعطاء، البغض والوداد، الزور والرشاد، الباطل والاهتداء…… وغير ذلك من متناقضات في كتابات وسمعيات ومرئيات كل من أراد الدفاع عن فكره في في إنتاج مكتوب أو مسموع أو مرئي.
هي أيضاً المجال الرحب لممارسة الحرية المطلقة في قراءات القراء والباحثين.
هي أيضاً المؤسسة المدافعة عن الهوية الوطنية، الشخصية التاريخيّة، الحيثية المجتمعية، والثقافة الجماهيرية.
هي أيضاً الكيان المحافظ على الأخلاقيات القيمية، الفلسفات الفكرية، والمعتقدات الدينية.
هي كل هذا وأكثر من هذا أيضاً.
فما هو دور المكتبات العامة في المجتمعات؟
تقوم بكافة الأدوار التي تؤدي إلى غذاء: العقل والروح والنفس، الرغبة والحاجة والبذل، المعلومات والمعرفة والعلم، الوعي والإدراك والفهم، الفكر والفلسفة والبحث، الأدب والبلاغة والنقد، الجرح والتقويم والضبط، القيادة والريادة والحكم، التمكين والاستقلال والعزم …. وغير ذلك من أدوار مركزية محورية مهمة لبناء المواطن القادر على بناء الوطن وحماية مقدراته. فالمكتبة من أهم القوى الناعمة البانية للمجتمعات، الناشرة للثقافات، المحافظة على الأخلاقيات والمفجرة للطاقات والملكات.
قيمة المكتبة في المجتمعات:
عليّنا أن نؤمن بقدسية المكتبة! وهنا يتساءل المرء منّا قائلا (كيف هذا وهي ليست مسجداً أو كنيسة أو معبداً يعبد فيه الإله؟ دعوني أولا أن أوضح معنى مفهوم مصطلح ” مقدسة أو قدسيةً ” مجتمعية، ومؤسساتها وأنواع المهن المقدسة فيه.
١. المؤسسات المجتمعية المقدسة:
هي المؤسسات التي نسعى سعياً حثيثاً لإنشائها في مجتمعاتنا والمحافظة على بقائها والدفاع عن كينونة وجودها بأوقاتنا، وأموالنا حتى بأرواحنا، ومنها هذه المؤسسات:
الأسرة، المسجد(دور العبادة)، المدرسة، المكتبة، وحتى إني أدخل معهم منظومة مؤسسات المجتمع المدني الساهرة على خدمة أبناء المجتمعات التي يعيشون ويعملون في كنفها!
فقدسية الأولى (الأسرة) مستمدة من الحفاظ على بقاء النسل البشري.
وقدسية الثانية (المسجد) مستمدة من غرز بذور الإيمان والقيم والأخلاق في أفئدة المجتمعات.
وقدسية الثالثه (المدرسة) مستمدة من نشر العلم والمعرفة.
وقدسية الرابعة (المكتبة) مستمدة من رفع الوعي والإدراك المجتعيين لدي أبنائها.
وقدسية الخامسة (مؤسسات المجتمع المدني) مستمدة من مقدار الخدمات المتجردة التي تقدمها للمستضعفين من أبناء الوطن ومن الفقراء والمحتاجين.
أما المهن المهن المقدسة في المجتمع، فهي المهن التي من خلال القيام بها يدافع ممتهنوها عن المواطنين بدمائهم وأرواحهم، ومنها:
مهنة الجيوش وتالتي تستمد قدسية مهنيتها من الدفاع عن الوطن.
مهنة الشرطة والأمن والتي تستمد قدسية مهنيتها من الدفاع عن المواطن.
مهنة الإنقاذ وإطفاء الحرائق والتي تستمد قدسية مهنيتها من إنقاذ المواطن من الهدم، الغرق والحريق.
فالقدسية (الحرمة) هنا ليست قدسية العبادة الإيمانيّة وشعائرها، بل قدسية أو حرمة المواطن – وخاصة المسلم – هي ما رواه عبد الله بن عمر: قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو يطوف حول الكعبة ناظراً إليها بعد فتح مكة – ويقول (ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وإن نظن به إلا خيراً) رواه ابن ماجه.
المسلم أعظم حرمة من الكعبة، جمال عبد الناصر، الأهرام ، العدد ٤٦٢٥٤، السنة ١٣٧، ٢٠١٣/٧/٢٧.
وفي تصحيح للألباني (ما أطيبك وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه) صححه الألباني، ابن ماجه.
وتأتي الآية الكريمة في سورة المائدة لتعلن للعالم أجمع وفي كل زمان عن حرمة أو قدسية الإنسان (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) المائدة ٣٢، مدى حرص الإسلام على حماية وحفظ النفس البشرية دون أن يفرق بين الأنفس المسلمة وغيرها من الأنفس الغير مسلمة.
إسلام ويب، الفتوى، تفسير من قتل نفسا بغير نفس ٢٠١٨/٤/٣، ٢٣٩٠١٩، ٣٧٤٠٧٤. islamweb.net
لماذا تدمر المكتبات ؟
في بعض الأحيان يتم تدمير المكتبة ” عمداً ” كشكل من أشكال التطهير الثقافي.
Isis destroys thousands of books aka manuscripts in Mosul libraries, Fadhil, Munda ^ 17-05-2023, مؤرشف من الأصل 2015/2/26, الغارديان.
يقول الشاعر الألماني هاينريش هانيه (١٧٩٧ – ١٨٥٦)، ” حيث تحرق الكتب…. يؤول الأمر إلى حرق البشر”. ويرجع الكاتب خالد السعيد في كتابه (حرق الكتب … تاريخ إتلاف الكتب والمكتبات) أسبابها إلى أسباب شرعية، سياسية، اجتماعية قبلية، نفسية وتعصبية.
لماذا يحرقون المكتبات ؟ حبيب شحادة، الميادين، ٢٠٢١/٦/٢٥، almayadeen.net
ومن وجهة نظري الخاصة فإن المكتبة تعد إرثاً نفيسا تراثيا، علميا، معرفيا، حضارياً لا يقدر بثمن. بدأ تدوين حريق المكتبات بحرق مكتبة الإسكندرية الملكية كأول مكتبة عامة عرفت في التاريخ، والتي كان بها مجموعة من الكتب يصل عددها آنذاك إلى ٧٠٠،٠٠٠ مجلد، والتي أنشأت على يد خلفاء الاسكندر الأكبر.
أقدم أربع مكتبات في العالم. مؤرشف من الأصل ٢٠٢١/٤/٢٠. اطلع عليه بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥.
مكتبة الأسكندرية، أقدم مكتبة في العالم القديم، ar.m.wikipedia.org
ومن المكتبات الشهيرة التي أحرقت:
٠ مكتبة آشور با نيبال بالعاصمة الآشورية سنة ٦١٢ قبل الميلاد في العراق.
مكتبة القسطنطينية بعاصمة الدولة البيزنطية في عام ٤٧٣ قبل الميلاد ،
٠ مكتبة برسيبوليس الفارسية سنة ٣٣٠ قبل الميلاد.
٠ مكتبة بغداد ١٢٥٤ م على يد التتار (المغول).ar.m.wikipedia.org
وهذه بعض المراجع للقراءة عن ما حدث للمكتبات العامة عبر العصور:
حرائق مخازن المعرفة على مر العصور… المكتبات وتاريخ انتصار الهمجية، عبد الرحمن مظهر العلوش، ٢٠٢١/٣/٥ aljazeera.net
ظاهرة تخريب الآثار وإحراق المكتبات في تاريخ المسلمين، أحمد عصيد، لكم، من هنا نبدأ الحرية lakome2.com
الحوار المتمدن، أحمد عصيد، ٢٠٢٠/٧/٣ m.ahewar.org
الفلوجي: مكتبة قرطبة من أشهر المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية، خالد الجبالي، الهيئة الوطنية للإعلام، ٢٠٢٣/٩/١٦،maspero.eg
٥٣ ٠٧ من صباح الخميس ٤ إبريل ٢٠٢٤، المنزل، برمنجهام بريطانيا.
إن من كلّ ما تقدّم نستنتج قيمة المكتبات العامة التي يخشاها الطغاة والظلمة من الحكام والغزاة المحتلين. وحتى المنتصرين في الحروب الأهلية كما حدث لمكتبة الكونجرس – التي تأسست في ١٨٠٠/٤/٢٤ بمرسوم رسمي وقع عليه الرئيس الأمريكي جون آدمز والتي ظل موقعها في الكونجرس حتى سنة ١٨١٤ عندما أحرقها الجنود الإنجليز.
مكتبة الكونجرس …. أكبر المكتبات في العالم. ٢٠٢٣/٣/٣، الجزيرة، الموسوعة | تعليمي aljazeera.net
فتعد المكتبة منارة:
للفهم والوعي والإدراك، الثقافة والفلسفة والفكر، التاريخ والحاضر والمستقبل، الحرية والتحرر والثورات، الإبداع والابتكار والاختراع، العقيدة والإيمان واليقين، الأدب والتذوق والفنون …. لذلك يخشاها الحكام الطغاة والغزاة الذين يريدون تزييف حقائق التاريخ!
فالمكتبة ليست فقط مكانا للقراءة والاطلاع والدراسة والبحث فحسب، بل هي أيضاً معلماً حضارياً يعبّر عن مدى تقدم الشعوب واهتمام دولهم بإبراز هذا التقدم والتحضر من خلال بناء هذا الصرح الحضاري الثقافي. لذلك قبل الكونجرس الأمريكي مكتبة توماس جيفرسون لتعويض الدمار في مكتبة الكونجرس في عام ١٨١٥ والتي كانت تضم ٦٤٨٧ كتاباً وتم الإعلان عن تأسيس المكتبة الوطنية. نفس المرجع السابق، الجزيرة.
فتعد المكتبة الوطنية العامة – بالنسة إلى الكثير من الدول – عجيبة كعجائب الدنيا السبع كالأهرامات، حدائق بابل المعلقة، سور الصين العظيم، تمثال زوس في أوليمبيا، معبد أرتميس في إفيسس، ضريح موسولوس في مدينة هليكارناسوس، تمثال رودس، منارة الإسكندرية، والذين يعبرون عن أهم الإبداعات التي صنعها الإنسان في القديم.
فإن أردنا أن ننجح هذه المؤسسة فلا أن يتوفر لهذا النجاح عدة عوامل:
٠ إيمان الدولة – وحكوماتها المتعاقبة – بالدور المحوري المركزي الذي سوف تقوم به المكتبة.
٠ جعل المكتبة مؤسسة مستقلة – سياسيا – عن مؤسسات الدولة السياسية – وهذا العامل لابد أن يتوفر أيضاً لكل من المسجد والمدرسة (المؤسسة الدينية والمؤسسة التعليمية) – فلا تتأثر بتغير سياسة الحكومات المتعاقبة.
٠ أن لا تختار ” الحكومة ” مسؤوليها – وهذا ما لابد من توفره للمسجد والمدرسة – بل يختارهم المجتمع من خيرة أبنائه من المتخصصين الخبراء الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والحيادية والالتزام والاستقلالية التوجيهية، وذلك من خلال مجالس هياكلها المعتمدة – وينطبق هذا أيضاً على المسجد والمدرسة – لأهمية اعتماد شفافية اتخاذ قرار الاختيار.
٠ أن يصدق على قرارات اختيار المسؤولين وتحديد ميزانية التسيير مجلس الشعب أو البرلمان، أو الكونجرس أو المجالس التي تشابهها في الدول المختلفة، حتى نضمن سلامة استقلاليتها، وكذلك المسجد والمدرسة.
٠ أن يكون ” الأمين العام ” شخصية وطنية مستقلة يجتمع عليها الجميع فهو – والإمام الفقيه والمعلم المربي العالم – لا يقل أهمية للوطن عن شخصية رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء!
هذا ما أراه واضحاً جلياً في استقلالية هذه المؤسسات الثلاث (المسجد والمدرسة والمكتبة) والت يضاف إليها أهمها مجتمعياً، فبدون استقلاليتهم لن نستطيع إيجاد مجتمعات تبنى نهضات وتشيد حضارات وتحافظ على المقدرات وتحقق الإنجازات وتحمل الرايات التي تعبر عن أهداف الرسالات المراد نشرها في ربوع الحيوات. دعونا الآن نتمعن في النظر إلى ودراسة هذا الجدول الذي يضع لنا خصائص شخصية قادة هذه المؤسسات!
الجدول:
رسالتي إلى الشباب:
إن هذا السرد الذي قد يعتقد البعض أنه ” ممل “، كلا والله بل إنّه ” مطل ” بظلال أغصان وأوراق أشجاره على أجيالكم المتعاقبة، فهو يحقق التالي:
٠ أن ندرك ونعي أن أهم أربعة شخصيات مجتمعية تستطيع – ليس فقط بناء المجتمعات بل – بناء القيم والأخلاق، والفكر والثقافة، والعلم والمعرفة، والانتماء والوطنية، والشخصية السوية، والقيادات المستقبلية هم:
الأم والأمومة، الإمام الفقيه والتفقه، المدرس العالم والتعليم، الأمين الباحث والبحوث. وهذه رسالة واضحة وجليلة وجلية لنا جميعاً تعني بأولوية ” الاستثمار في الموارد البشريّة “.
٠ أنّ نحرص على بناء المؤسسات المستقلة لا تقديس الزعامات المستغلة. فإن أسسنا المؤسسات على مبادئ استقلاليتها المجتمعية وحماية الدساتير والقوانين والسياسات والهياكل والتشريعات لمسيرة استقلاليتها المجتمعية، لزهت أوطاننا بزهو هذه المؤسسات الأربعة (الأسرة، المسجد، المدرسة والمكتبة).
٠ أن نجعل التكنولوجيا أداة نجاح لا مسيرة عبادة،
أن نستعملها لإنجاز أعمالنا لا لعزلتنا عن مجتمعاتنا،
أن نجعلها مضيئة لطرقاتنا لا مضيعة لأوقاتنا،
أن نجعلها محللة لنتائج بحوثنا لا مضللة لنا،
أن نجعلها ناشرة لأبعاد رسالاتنا لا مغيرة لفكر أجيالنا،
أن نجعلها منقحة لاستقلالية مؤسساتنا لا مغيبه لعقول شعوبنا،
أن نجعلها راسمة لخرائط طرقنا لا ماحيه لذاكرة تاريخنا،
أن نجعلها مصححة لما كتبوه عن حضاراتنا لا مزورة لإنجازات أسلافنا،
٠ أن تصبحوا يا شباب صناع المرحلة القادمة من التكنولوجيات القيميّة الهادية، وما المرحلة القادمة إلا جزء يسير من مسيرة صناعة مستقبل إحياء حياة الأمم.
٠ أن نفقه ما نعلم، نناقش ما ندرك(أبعاد مخرجاته)، ننتج ما نريد استعماله، نصنع ما تحتاجه مجتمعاتنا، نستثمر في ما يبني أجيالنا، نلملم شتات جمعنا، نزرع ما يكفي شعوبنا، نداوي اختلاف آرائنا، نقرب وجهات نظرنا، نسدد ونصوب ما يجمع شملنا، نعيذ من يستعيذون بنا، نتنازل عن جزءا من اعتبارية شخصياتنا، نتعايش ونتعامل مع أديان وثقافات ومعتقدات أبناء وطننا.
إن ما أريد أن أراه فيكم وأريدكم أن تحسنوا صناعته يا شباب هو صناعة الإحسان، فهي الصناعة التي أعجزت ملايين البشر عن القيام ببناء هياكل كياناتها. الإحسان لأنفسنا بتزكيتها، الإحسان لمجتمعاتنا بإعمارها، الإحسان لشعوبنا بتمكينها، الإحسان لمؤسساتنا باستقلالها، الإحسان لأسرنا بتبصيرها، الإحسان لحكامنا بجميل نصحها، الإحسان للحياة بحبّها، الإحسان للحضارة بتشييدها، الإحسان للعدالة بترسيخها، الإحسان لأعدائنا بمكاشفتها، الإحسان للضمائر بإصلاحها والإحسان للسرائر بتنقيتها. هذا من الجانب الفكري الثقافي الفلسفي، أما من الجانب التطبيقي الاجتماعي العلمي، فعليكم يا شباب أن تعضوا بالنواجذ على أقامة هيكل كيان الحرية الذي لا يهدمها عليكم أحد ولا يغتصبها أو ينتزعها منكم أحد. فالحرية هيكل وكيان، رسالة وإيمان، قول وبيان، حال ومكان، شعب وزمان، أمن وأمان، عز ووئام، روح وسلام، رفعة ومقام، رقي ومهام.
أيها الشباب لن نستطيع نصنع الإحسان ونبني هياكل كيانات الإحسان والحرية إلا إذا بنينا هذه المؤسسات الأربعة وحافظنا على كينونة بقائها، الأسرة والمسجد والمدرسة والمكتبة، فهنيئا لنا ببدء المسيرة جنبا إلى جنب.