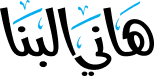“الحضارة فكرة”
قد يصعب على المرء منا ان يتصور نشأة الحضارات والمراحل التي مرت بها تلك الابداعات المجتمعية لإنشاء هذه الحضارات لماذا؟ لأننا نرى آثار الحضارات التي قامت على ارض المعمورة من الآف او مئات السنين. ولكن على المرء منا ان يتصور كيف نشأت هذه الحضارات وكيف بناها اصحابها من المؤمنين بها. فهي ابسط من ان يتخيلها المرء، لان فكرة انشاء الحضارات الحضارية كامنة داخل فؤاد المرء منا. من استطاع منا ان يكتشفها فيهذبها وينميها ويرعاها يجعلها قادرة على تخطي الحدود المجتمعية لانشاء الحضارات الانسانية. فالكل منا سواء في الخلق. فالخالق عادل أعطى كل خلقة نفس الحيثيات والخصائص فمن اكتشفها منا تميز بها عن الآخرين. اذن فالحضارة في نظرتي القاصرة الضعيفة ماهي الا فكرة لدى كل منا.
اما الامر الآخر الذي اؤمن به فهو انه لايوجد مجتمعاً بشرياً او خلائقياً لم يستطع من ان يطور نفسه ويقيم بها خصائص حضارية على ارض هذا المجتمع. فالكل – منا – متحضرين وقادرين على انشاء الحضارات وان اختلفت معاييرنا المجتمعية وامكانياتنا البشرية والمادية المجتمعية. فأهل الغابات والكهوف والقيعان لهم حضارة يغزلون خيوط انسجتها داخل قيعان هذه المجتمعات واهل ناطحات السحاب والافلاك الخارجية والفضاءات الكواكبية يرسمون مسارات حضاراتهم داخل هذه الافلاك المترامية الاطراف. والكل امام التاريخ سواء فالكل متحضر والكل مبدع والكل مطور والكل مجدد!!!.
ان ما سوف اطرحه الآن ليس بجديد! او غريب! وأتمنى ان لا يستغربه او يستهجنه احد !! فهو اطروحة ثمانية الاضلاع او ثمانية الخطوات تعلمتها من خلال استقرائي للمجتمعات التي زرتها والتعاملات التي تفضلت عليِّا هذه المجتمعات بفعلها. فأشكر فيها اولاً الخالق سبحانه وتعالى ثم من بعده ابناء هذه المجتمعات الراقية (و جميعها راقية) والفقيرة (وجميعها فقيرة) – الى الله – والغنية (وجميعها غنية) بما اعطاها لها الله من امكانات. فما هي هذه الثامنية التي تنشئ الحضارة. هي ثمانية خطوات، السبع الاولى منها تحدث الثامنة وكلها متتابعة كالتالي:
- الفكرة
- المشروع
- الجمعية (التنظيم)
- المؤسسة
- الفكر
- الثقافة
- الحضارة
- التاريخ
- الفكرة: هي مايدور بخلد المرء منا فيراجعها وينقحها وينميها خلال فكرة التفكر فيها قبل ان تتملكه في حركاته وتفاعلاته مع من حوله ممن يثق فيهم. فحينما يتملكه الايمان بها، ايماناً يقيناً يبدأ في عرضها على من حوله من اصدقاء ومحبين واقارب يثق بهم ليجعلهم جميعاً مؤمنين بها مثله. وقد تستمر هذه الفترة ما بين الاسابيع الى الاشهر وقد تطول الى عام او اكثر حسب درجه ايمانه (ايمانها) بفكرته، ثم ايمان من حوله (حولها) ثم معرفة واقعية ايمان المجتمع بها.
فإن حدث هذا خلال احدى هذه الفترات وتجمع حوله (حولها) هذه المجموعة من المؤمنين بالفكرة (وليس الشخص فقط بدأوا جميعهم في التفكير في الخطوة الثانية. مرحلة التنفيذ واختبار هذه الفكرة مجتمعياً وهي تحولها الى مشروع. - المشروع: تجتمع هذه المجموعة (المؤمنة بالفكرة) لدراسة امكانية تحويلها الى مشروع يخدم المجتمع. يكن بسيط في تنفيذه، سهل في قيادته، محدود في جغرافيته، غير مكلف في ميزانيته، قصير في مراحله، مراجع في خطواته. ويبدأ هذا الجمع المؤمن في تحديد ابعاد تنفيذ هذا المشروع في هذا الحيز على مستوى الشارع، الحي ، القرية، المدينة، حتى لا يتوسعوا فيتسع خروق رقعتهم المجتمعية عليهم. فالأهم هنا هو الحصول على نتيجة مجتمعية مفيدة ومحققة لاهداف المشروع (الفكرة) في وقت قصير قد يبهر المجتمع المستفيد من هذا المشروع.
وفي خلال هذه الفترة يصبح من حق هذه المجموعة مراجعة خطوات تنفيذ المشروع وانجازاته واخفاقاته لكي يستيطعوا توسيع رقعة تنفيذه وتوسيع رقعه الاستفادة منه قبل ان ينتقلوا به الى المرحلة الثالثة. وشرط نجاح هذه المرحلة والانتقال الى المرحلة الثالثة هو التركيز على “الفكرة” وليس على الاشخاص الذين ينفذون مشروع تطبيق الفكرة مجتمعياً. وقد تستمر هذه المرحلة لعام او عامين او اكثر او اقل (شريطة الا تقل عن عام يختبر فيه المشروع لدورتين او ثلاث) حسب قدرات المؤمنين بفكرة تنفيذ المشروع. وبعد هذا ينتقلوا بالمشروع الى المرحلة الثالثة من تنفيذ واختيار الفكرة وهي التي تسترعي المؤمنين لها الى ان يصبحوا اكثر تنظيماً ويحولون هذا المشروع المدار من خلال مجموعة الى تنظيم او جمعية تدير هذه الفكرة وهذا المشروع.
- التنظيم (الجمعية): في الماضي لم يكم هناك جمعيات (كالتي نراها اليوم) تديرهذه المشاريع فكان المجتمع ينشئ تنظيمات علنية (بعضها سرية) لإدارة هذه الفعاليات المجتمعية حسب المناخ الديمقراطي الذي كان يتمتع به ابناء هذه المجتمعات. والآن نطلق على هذه التنظيمات اسم جمعيات مجتمع مدني اهلية وخيرية فيتحدد في اطار هذه الجمعيات الانشائي الهياكل الداخلية، الاهداف، الرسالة، الرؤية، التمويل وسائل المراجعة والشفافية والمحاسبة الداخلية والخارجية، الهرم الاداري للجمعية، الميزانيات، حقوق العالمين وحقوق الاعضاء وصلاحيات الاجهزة وخلاف ذلك من قوانين ولوائح.
ولكن لابد وان نبني كل هذه الهياكل الادارية والمرجعيات المحاسبية والبرامج الخدمية حول شئ واحد فقط (وازيد من التأكيد عليه) وهو “الفكرة” التي من اجلها انشأ المشروع واسست الجمعية. وليس المؤسس او المؤسسون او الجمعية ذاتها. فالمؤسس والمؤسسين لهم سقفاً فكرياً عطائياً قد تريد الفكرة ان تنمو (في تنفيذها المجتمعي) فوقه فلا يستطيعون نقلها الى المستويات الاعلى. وكذلك الجمعية فالجمعية هي الوسيلة التي من خلالها نحقق الفكرة. ان عنق الزجاجة الحاجز للنمو المؤسسي داخل الجمعيات والذي في بعض الاحيان مانع لنموها هو :
- شخصنه العمل المرتبط بالمؤسس وقيمته
- شخصنه العمل المرتبط بحتمية بقاء الجيل الاول دائماً وان قل عطائهم وانعدم في بعض (كثير) من الاحيان.
- الاهتمام بالهياكل الادارية واللوائح على حساب الفكرة. فعلينا ان نتوازن في الاهتمام بكليهما.
والجمعية التي تريد ان تخرج من المرحلة الثالثة الى المرحلة الرابعة هي الجمعية ” المعلمة المتعلمة” اي التي يتعلم صغيرها من كبيرها وكبيرها من صغيرها. وتتعلم ايضاً من المجتمع المحلي وما هم دونها من الجمعيات الاهلية وكذلك من المجتمع الدولي وما هم ارقى منها في الاداء والعطاء. وتتعلم ايضاً من العاملين في الدوائر الحكومية والدوائر العرفية والعادات والتقاليد والثقافات المجتمعية المتعرف عليها. الجمعية التي لا تبدأ دائماً من رقم “الصفر” بل تبدأ من حيث ما انتهى الآخرين. التي تثق في قدرات ابنائها واعضائها قدر ما نثق في قدرات وعطاءات ابناء المجتمع الاوسط التي لا تحجب نفسها عن العامة، فالعامة هؤلاء هم الجبل السري الذي لا ينقطع عطائه. الجمعية التي لا تجعل من نفسها نادياً لنخبة او حزباً بالجماعة او تابعة لتنظم. فناديها الوطن وحزبها الشعب وتبعيتها لآمالهم واحلام وتخفيف آلامهم. فان استطاعت الجمعية ان تفعل هذا فسوف تنتقل حتماً الى المرحلة الرابعة وهي التحول الى “المؤسسة”.
انني استطيع ان “أجزم” – وانا صادق في هذا – بأن اكثر من 90% من مؤسسات وجمعيات العمل الخيري العربي – وخاصة – الاسلامي تقع في مستوى مادون المستوى الحرفي المؤسسي لاسباب عدة. وان القلة منهم – والتي ان كان لديها الامكانات المادية والبشرية والبرامجية للمؤسسة – فهي مازالت تفكر بعقلية الجمعية العضوية التقليدية وليس بعقلية المؤسسة التمكينية – للافراد والمجتمع – الفكرية التجددية الاجتهادية.
والشرط الآخر للنمو للمرحلة الثالثة هو التركيز على تفعيل الفكرة وليس النظر الى المفكرين والمؤسسين بالدرجة الاولى. وقد تستمر هذه المرحلة لعشر سنوات او اكثر وصعب ان تتحق في فترة اقل من عشر سنوات. ولكن للحياة المجتمعية سننا غريبة !!!
- المؤسسة: ان الفارق الاعظم – في نظرتي القاصرة – بين الجمعية والمؤسسة هو الملكية والحوكمة. وهما بيت القصيد في ورقتنا هذه وهو السبب الاول في عدم نمو الآلاف من الجمعيات الى مرحلة الحرفية ثم المؤسساتية الفكرية التنفيذية. فالمؤسسة يكن لديها التالي:
- الدرجة المتقدمة العليا من التفكير المعلوماتي المعرفاتي المرن والقادر على استيعاب المناخات والبيئات المتعددة الى اتى منها اعضائها وابنائها من العاملين. فهي تسعهم جميعاً لان فكرها يتكون من كل فكر آمن به اعضائها والعاملين فيها.
- هي التي لديها الثقة لتمليك فكرتها للمجتمع واعضائها والعاملين فيها بالدرجة الاولى. فالفكرة ليست فكرة فرد او مجموعة بل هي فكرة المجتمع الذي انشأ هذه الجمعية وتلك المؤسسة.
- التي تضع انظمة لتتابع تمكين القيادات بالالتزام بمعايير الشفافية، المصداقية، الاحترام، الثقة، العدل حتى وان كان هؤلاء من خارج الأطر والكوادر الوظيفية ومن خارج هياكل عضوية الجمعية.
- هي التي لا تألوا عن الاستماع والتدوين لتصحيح المسار فتجعل المجتمع مرآتها والمواطنين ناصيحها والمتخصصين مستشاريها وكوادر الحكومات والجمعيات والمؤسسات الاخرى شركائها.
- هي التي تؤمن بأن المالك الحقيقي لها ومقدراتها هو الفقير والمريض واليتيم والارملة. هو المجتمع الذي أنشأت من اجله فتلتزم بإعطائه اقدر قدر من مستحقاته كي تنمية وتكتفي بالقدر الايسر لتنمية نفسها.
- وهي ايضاً التي تركز على “الفكرة” وتحاول تنميتها ونشرها كي تنتقل بها الى المرحلة الخامسة (الفكر). فتنتقل هذه الفكرة بفعاليتها وامكاناتها لكافة الدوائر المجتمعية المحلية (الاهلية منها والحكومية) والدولية. فتتحول هذه الفكرة في النمو الرأسي للجمعيات فتنقلها الى مرحلتها الخامسة “الفكر” وقد تستمرهذه المرحلة فترة لا تقل عن عشر سنوات لان تغيير الفكرة الى فكر ووضع برامج توعوية لايحدث (ولن يحدث) بين عشية وضحاها. فان اردنا ان نهيئ هذه البرامج وهذه التفاعلات فقد لا نستطيع ان ننجزها قبل هذا والله اعلم!!!.
- الفكر: هو التحدي الرابع والمرحلة الخامسة وهو كيف ننشر هذا الفكر الذي ابدعت في تكوين اركانه المؤسسة ونجعله فكراً مجتمعياً وليس فكر مؤسسة فقط. وهنا لا بد ان يكون دور المؤسسة ايجاد مناخات حوارية، تثقيفية، تعليمية، توجيهية يتبناها المجتمع الذي تعيش من اجل خدمته من خلال:
- مصداقية المؤسسة ومرجعياتها الفكرية والادارية
- مدى تأثير البرامج المجتمعية ايجاباًعلى الشارع المجتمعي
- من هم المتعاونين مع المؤسسة من الشخصيات العامة، جمعيات المجتمع المدني ومؤسساته الاهلية، الدوائر الحكومية والدوائر الاكاديمية وخلاف ذلك من شركاء
- دور الشباب في السعي لنشر هذا الفكر وكيفية التعامل مع فعالياته والاستجابة لمتطلباته
- دور المؤسسات التقليدية القيمية والثقافية والدينية في التعامل مع نشر هذا الفكر وجعلهم احد الشركاء الفاعلين والمؤثرين في ايصال هذا الفكر للمجتمع
- دور المجتمع الذي يؤمن بأن هذه الفكرة وهذا الفكر وهذه المؤسسات مكتسبات وممتلكات مجتمعية وطنية لها اجندات مجتمعية خدمية وطنية واحدة وواضاحة.
- ان تكون كل هذه الادوار متناسقة ومتكاملة وليست مفروضة من جهة ما ذات نفوذ ما على المجتمع. وان تأخذ عجلة التدافع الفكري الجدلي مجراها (البطئ) من اجل زرع ذلك الفكر المجتمعي الجديد الذي سينشأ مناخاً جديداً يحاول ابراز ثقافة جديدة من خلال هذه الأطر والاطروحات والاجتهادات التجديدية المجتمعية التي شعر فيها الجميع انهم مالكون لها.
فأن استطعنا ان نحافظ على قيادة عجلة العربة (المؤسسة) الناشرة لهذا الفكر فسوف نستطيع احلال الفكر القائم التقليدي بفكر آخر تجديدي مجتمعي. وتستمر عجلة الانتشار الفكري لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً لكي يصبح هذا الفكر جزء لا يتجزء من التفكير المجتمعي. وهنا قد ينتهي دور المؤسسة شكلياً لانها هي التي حولت الفكرة الى فكرتهم دفعت به الى المجتمع ليمتلكه ويجعله جزءاً من فكرة فتنشغل المؤسسة بالتالي:
- تطوير هذا الفكر وتنميته
- انشاء فكرا آخر ليتكامل او يجدد هذا الفكر الذي انشأته من قبل
- التعاون مع الآخرين
- ان تصبح مرجعية فكرية مجتمعية
- تشجيع المبادرات الفكرية الاخرى وتنميتها للاستفادة من خبراتها.
- الثقافة: هي ما يعبر بها المجتمع عن قيمة وعاداته وتقاليده وايماناته وتعدداته الفكرية والثقافية والعرفية. وعلى تاريخة وواقع آماله.
وقد تظهر هذه الثقافة في اشكال عدة منها المطعم والمشرب والملبس ومنها الغناء والموسيقى ومنها انواع الفنون المختلفة التي يبرزها المجتمع ومنها مراحل التحول الديمقراطي السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي ومنها العرف الذي حكم هذه المجتمعات لقرون عدة قبل تقنين القوانين ونزول الرسالات السماوية .
فالفكر المجتمعي هو القادر والوحيد على تحويل نفسه داخلياً الى ثقافة مجتمعية خارجية معبر عن مكنون الايمان بهذا الفكر المجتمعي لدى ابناء هذا المجتمع والثقافة هنا هي التحدي الخامس والخطوة السادسة.
وسيصبح دور هذه الثقافة هو التالي:
- الحفاظ على المناخ المجتمعي الذي انشأة هذا الفكر الجديد
- السعي لتحويل هذا الفكر وهذه الثقافة الى حضارة في كافة مناحي الحياة المجتمعية لها.
ولكن شريطة ان تكون هذه الثقافة قائمة على انماء المجتمع والفكر الذي انشأه اصحاب الفكرة الاولى وليس تخليدهم (فقط) او تأليههم. لان الفكرة لم تنمو فقط في العشرية الاولى من عمرها بل تتابع عليها الآلاف او حتى الملايين من ابناء هذا المجتمع الذين آمنوا بها وسعوا الى تحويلها من فكرة الى فكر وثقافة مجتمعية. فالمسيرة التي بدأت بالفرد او المجموعة سار فيها الملايين الى ان اصبحت ثقافة تقدر الفرد والمؤسسين والمبدعين والمواطنين العاديين المغمورين الذين ساهموا بدعائهم لعدم الاستطاعة بالمساعدة بمجهودهم. فان نجحت هذه الثقافة المجتمعية في تنمية فكرها المجتمعي داخل دهاليز واروقة مجتمعاتها الصغيرة والكبيرة لاستطاعت في هذه الفترة التي قد تصل الى عقدين او اكثر من الزمان ان تؤسس للقواعد الحضارية المتشابكة والمنشئة لحضارة مستقبل هذه الامة ومجتمعاتها المتباينة والمتناسقة التي تتناغم في اعمالها وتتكامل في رؤاها وتجعل العالم ينظر اليهم في دهشة واستغراب واستحسان فهم المبدعون من المتحضرين المجتمعيين.
- الحضارة: والتحدي السادس امامنا والخطوة السابعة هي انشاء الحضارة الانسانية التي نتحدث عنها الآن. لا تبدأ حضارة مجتمعية ولا تنمو شجيرات غاباتها ولا تترعرع بين هذه الشجيرات وداخل اعماق هذه المجتمعات تلك الثقافة التي راعاتها الملايين من الايدي من خلال الحفاظ على فكرة الحضارة الاولى التي انشأها فرداً مخلصاً او مجموعة من الافراد المخلصين والمتجردين الا اذا توفر فيها الركن الاساسي من اركان بناء هذه الحضارة وهو الايمان بالفكرة والتركيز على خدمتها لتحقيق اهدافها ولو طال الزمن وتتابعت الاجيال.
فسوف نجد بعد هذه التتابعات وهذا التفعيل المجتمعي وهذا التمكين وهذه الملكية العامة التي يتمتع بها كل فرد من افراد المجتمع (الوطن) سوف نجد ان كل وتر داخل الآلالت المجتمعية العازفة لسيمفونية الحضارة الانسانية يقوم بدوره في التمايل يميناً وشمالاً وبعيداً وقريباً عن الآله التي يتشكل فيها نغمة متوافقاً مع اوتار الآلات الاخرى لتعزف لنا هذه الآلات المجتمعية بسموفنيات الحضارات الانسانية. ولوجدنا كل فرد يحلم بما يحلم به اقرانه في المجتمع الكبير مهما صغر كان فقيرا ام غنيا، رجلا او امراة، طفلا او شيخا، عالما او عابرا. لان الكل يحلم بتحقيق حلم اقامة الحياة التي يسعى الى تحقيقه الجميع. فالحلم واحد وان كانت الوانه مختلفة. والحلم هذا يتكون من مشاعر واحاسيس وآمال وآلام الجميع. فالكل يعاني ويصبر والكل يجتهد ويعمل والكل يكل وصبر والكل يعرق وينصب والكل يحب ويرغب. اما الحب الذي يحلم به الكل فهو حب الوطن الذي يعيش فيه والمجتمع الذي يتكون منه ومن قربائه. واما الرغبة فهي في الخدمة والخدمة خدمات اعلاها حب خدمة المجتمع من اجل ابتغاء مرضاة الخالق سبحانه وتعالى. وادناها خدمة النفس التي قد تنحط بنفسها الى قاع قيعان المجتمعات السحيقة.
فالانسان قد خلقة الخالق سبحانه وتعالى لانشاء الحضارات لذلك خطاب فيه الخالق باقي ملائكته “اني جاعل في الارض خليفة” وهذا الخليفة يخلف الخالق في ارضه لينشئ الحضارات التي لم تقدر على انشائها الخلائق الاخرى.
ثم يعلم الخالق ذلك المخلوق العلم “وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكمة.. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ماعلمتنا انك انت العلام الحكيم”
وهنا يأتي دور العلم ” الفرضى” في حياة البشر. فالعلم الدنيوي الانساني مرتبط بعلم علام الغيوب واصبحت فرضية تعلم العلم قائمة ليست على المؤمنين فقط بل على كل انسان خلقة الله وعلمة كما علم ابيه ادم من قبل عليه السلام.
ثم على الخالق سبحانه وتعالى التدبر والنظر وتفقد ماحوله “وفي انفسكم افلا تبصرون” “فسيحوا في الارض” “سياحة أمتى الجهاد”…..” افلا يتدبرون القرآن…”
(ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار….سورة البقرة)
وكل هذا من آليات تجعل هذا المخلوق الطيني الذي استهزء به ابليس اللعين قائلاً لخالقه كيف اسجد لمن خلقته من طين.. (خلقتني من نار وخلقته من طين)..(فسجد الملائكمة كلهم اجمعين الا ابليس أبى..) فطرده الخالق من الجنه (فاخرج منها مذؤماً مرجورا عن تبعك منهم اجمعين) وليعلم ابن آدم الذي خلقة المولى خليفة له في الارض لينشئ الحضارات ان له في الدنيا صديقاً وعدوا. اما الصديق فهو القوم من الملائكه (الذين سجدوا له اجمعين) (والذين يستغفرون له ويحمونه ويسردون خطاه لانقاذه من العدو اللدود هادم اركان البشرية (ان فلح) الذي تحدى الخالق قائلا (لآتينهم عن ايمانهم وعن شمائلهم…) ومن امامهم ومن خلفهم….(ولأحتنكنهم اجمعين) ليقذفهم في سحيق نار جهنم خالدين فيها.
فلنكن ممن تستغفر لهم الملائكة وننشئ معهم الحضارات ولنستعيد بالخالق من اعوان ابليس واخوانه من البشر فان فلحنا انشأنا واقمنا الحضارات بإذن الله تعالى.
- التاريخ: اما التحدي السابع وخطوتنا الثامنة فهي في كتابة تاريخ كل هذه المنجزات والاعمال والمبادرات. فمن سوف يكتبها لنا.
نحن – كبشر – لن نستطيع كتابة التاريخ. ونحن كعمال حضاريين مجتمعيين سوف ننشغل ببناء الاعمال وليس بتسطير الاقوال. اما التاريخ فلن يكتب عن ماقلنا – لانه لم يكن معنا – بل سيكتب عن ما رأس من انجازات اعمالنا. فدعوا التاريخ يلهث وراء خطوكم ليسطر احلامكم ويبنى امجادكم. ان من انشغل – منا – بانجاز الاعمال الخدمية الحضارية المجتمعية تربطه بالتاريخ في خطوة وهمسة وضيقة وفرجه وفرحة وحزنه. ان التاريخ لا يسعى وراء من ارادوا ان يمجدوا انفسهم، بل يمجد من ضحوا بانفسهم لبناء حياة مجيدة للآخرين.
فأكثروا من بناء الانجازات المحدثة للتغيير الحضاري المجتمعي. قولوا للتاريخ “لا وقت لدينا للتحدث اليك، فأفعل ما شئت بما حققناه للأجيال ” . اجعلوا التاريخ يردد اشعار انجازاتكم ويعزف سيمفونيات امجادكم وييسر مسالك الحضارة للاجيال من بعدكم.
هذا هو التاريخ اللاهث الباحث عن الحقيقة وها هي انجازاتكم الحضارية التي تسطر فصول الحقيقة.
وأخيراً اريد ان اوضح ان كل هذه الدورة الحضارية لن تكتمل ولن تنجح ولن تثمر الا اذا تحقق في القائمين عليها بعض الاركان منها:
- الايمان بالفكرة والمجتمع والخدمة
- التواضع وخفض الجناح
- التجرد وانكار الذات
- تقديم الملكية المجتمعية على الملكية الفردية
- تمكين الكوارد البشرية المجتمعية
- تتابع التوارث بين الاجيال المتعاقبة
- احترام الآخرين والاعتراف بفضل انجازاتهم
- عدم استعمال سياسية الاقصاء والتهميش للآخرين
- ارجاع الفضل للخالق ومن بعده للمجتمعات والشركاء والافراد.